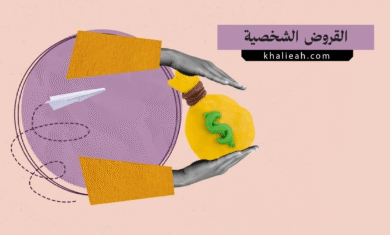ما هو التيسير الكمي (QE)؟ وكيف يُستخدم لإنقاذ الاقتصادات؟

في عالم الاقتصاد الحديث، تبرز أدوات نقدية غير تقليدية كاستجابة للأزمات العميقة. ومن بين هذه الأدوات، يظل التيسير الكمي الأكثر تأثيراً وإثارة للجدل على الإطلاق.
المقدمة: فك شيفرة الأداة النقدية غير التقليدية
يمثل التيسير الكمي (Quantitative Easing – QE) أحد أبرز الأدوات النقدية غير التقليدية التي تلجأ إليها البنوك المركزية في أوقات الركود الاقتصادي الشديد أو الأزمات المالية، خاصة عندما تصبح الأدوات التقليدية، مثل خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، غير فعالة أو تصل إلى حدودها الدنيا، وهو ما يُعرف بـ “مصيدة السيولة” (Liquidity Trap). بشكل مبسط، يتضمن التيسير الكمي قيام البنك المركزي بضخ أموال جديدة في النظام المالي عن طريق شراء أصول مالية، مثل السندات الحكومية أو الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، من البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى. هذه العملية تهدف إلى زيادة المعروض النقدي، خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، وتشجيع الإقراض والاستثمار، وبالتالي تحفيز النشاط الاقتصادي. لم يكن مفهوم التيسير الكمي معروفاً على نطاق واسع قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ولكنه أصبح منذ ذلك الحين حجر الزاوية في استجابات السياسة النقدية للعديد من الاقتصادات المتقدمة. إن فهم آلية عمل التيسير الكمي وتأثيراته المعقدة والمتشعبة يعد أمراً ضرورياً لتقييم دوره في إنقاذ الاقتصادات من حافة الانهيار، وكذلك لإدراك المخاطر والتحديات التي يفرضها على المدى الطويل.
تعريف التيسير الكمي: ما وراء شراء الأصول
عندما نتحدث عن تعريف دقيق للتيسير الكمي، يجب أن نتجاوز فكرة “طباعة النقود” الشائعة، والتي غالباً ما تبسط المفهوم بشكل مخل. في الواقع، لا يقوم البنك المركزي بطباعة أوراق نقدية مادية وتوزيعها، بل يقوم بإنشاء احتياطيات بنكية إلكترونية جديدة “من العدم” ضمن ميزانيته العمومية. هذه الاحتياطيات الرقمية هي التي تُستخدم لشراء الأصول المالية من السوق المفتوحة. تكمن أهمية هذه الآلية في أنها تؤثر بشكل مباشر على حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، حيث تزداد أصوله (السندات التي اشتراها) وخصومه (الاحتياطيات البنكية التي أنشأها). هذا التوسع في الميزانية هو ما يميز سياسة التيسير الكمي عن عمليات السوق المفتوحة التقليدية، التي تهدف عادةً إلى إدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير كبير في حجم الميزانية العمومية. وبالتالي، فإن جوهر التيسير الكمي هو التركيز على “كمية” الأصول المشتراة، وليس فقط على “سعر” المال (الفائدة). يهدف هذا الإجراء الكمي إلى التأثير على ظروف الائتمان في الاقتصاد بأكمله، وليس فقط في القطاع المصرفي. إن تطبيق التيسير الكمي يعتبر تحولاً جذرياً في فلسفة السياسة النقدية، حيث ينتقل البنك المركزي من دور المنظم السلبي لأسعار الفائدة إلى دور اللاعب النشط والمباشر في الأسواق المالية.
الآلية التشغيلية لبرامج التيسير الكمي
لفهم كيفية عمل التيسير الكمي على أرض الواقع، يمكن تقسيم العملية إلى سلسلة من الخطوات المترابطة التي تهدف إلى إحداث تأثير متسلسل في الاقتصاد. تتسم هذه الآلية بالتعقيد، ولكن يمكن تبسيطها في النقاط التالية:
- تحديد الهدف والإعلان عن البرنامج:
- يبدأ كل شيء عندما يقرر البنك المركزي أن الاقتصاد بحاجة إلى تحفيز إضافي وأن الأدوات التقليدية لم تعد كافية. يقوم البنك بالإعلان عن نيته تنفيذ برنامج التيسير الكمي، محدداً حجم المشتريات المستهدفة ونوعية الأصول التي سيتم شراؤها (كسندات الخزانة، أو سندات الشركات، أو الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري). مجرد الإعلان عن برنامج التيسير الكمي يمكن أن يكون له تأثير نفسي إيجابي على الأسواق، حيث يبعث برسالة قوية بأن البنك المركزي ملتزم بدعم الاقتصاد.
- إنشاء الاحتياطيات وشراء الأصول:
- يقوم البنك المركزي بإنشاء أموال جديدة في شكل احتياطيات رقمية. يستخدم هذه الاحتياطيات لشراء الأصول المستهدفة من البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى في السوق المفتوحة. نتيجة لذلك، تتلقى هذه البنوك سيولة نقدية جديدة (احتياطيات) في حساباتها لدى البنك المركزي مقابل الأصول التي باعتها. هذه الخطوة تزيد بشكل مباشر من حجم الاحتياطيات في النظام المصرفي.
- التأثير على أسعار الفائدة وعائدات السندات:
- عملية الشراء المكثفة التي يقوم بها البنك المركزي تزيد من الطلب على السندات والأصول الأخرى. وفقاً لقانون العرض والطلب، يؤدي هذا الطلب المتزايد إلى ارتفاع أسعار هذه السندات. هناك علاقة عكسية بين سعر السند وعائده (الفائدة)؛ فعندما يرتفع سعر السند، ينخفض عائده. وبالتالي، فإن الهدف المباشر لسياسة التيسير الكمي هو خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما يجعل الاقتراض أرخص للأفراد والشركات.
- انتقال التأثير إلى الاقتصاد الحقيقي:
- من المفترض أن تنتقل هذه التأثيرات من الأسواق المالية إلى الاقتصاد الحقيقي عبر عدة قنوات. مع انخفاض تكاليف الاقتراض، يتم تحفيز الشركات على الاستثمار في مشاريع جديدة وتوظيف المزيد من العمال، كما يتم تشجيع الأفراد على اقتراض الأموال لشراء المنازل والسيارات والسلع المعمرة. علاوة على ذلك، يؤدي ارتفاع أسعار الأصول (الأسهم والسندات والعقارات) إلى ما يعرف بـ “تأثير الثروة” (Wealth Effect)، حيث يشعر المستثمرون بأنهم أكثر ثراءً، مما قد يدفعهم إلى زيادة إنفاقهم الاستهلاكي. هذا التحفيز المزدوج للاستثمار والاستهلاك هو الغاية النهائية من تطبيق التيسير الكمي.
الأهداف الأساسية لتطبيق التيسير الكمي
لا يتم اللجوء إلى أداة قوية ومثيرة للجدل مثل التيسير الكمي إلا لتحقيق أهداف اقتصادية كلية محددة وعاجلة. تختلف الأولويات قليلاً من اقتصاد لآخر، ولكن الأهداف الأساسية تظل متشابهة إلى حد كبير، وتشمل:
- مكافحة الانكماش (Deflation):
يُعد الانكماش، وهو انخفاض مستمر في المستوى العام للأسعار، كابوساً للبنوك المركزية. فهو يشجع المستهلكين على تأجيل مشترياتهم أملاً في انخفاض الأسعار مستقبلاً، مما يؤدي إلى تراجع الطلب، وانخفاض الإنتاج، وزيادة البطالة في حلقة مفرغة مدمرة. يهدف التيسير الكمي إلى زيادة المعروض النقدي وتحفيز الطلب، مما يساعد على منع الأسعار من الدخول في دوامة الانكماش وخلق توقعات تضخمية معتدلة. - خفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل:
كما ذكرنا سابقاً، من خلال شراء السندات طويلة الأجل، يعمل التيسير الكمي على خفض عائداتها. هذه العائدات هي المعيار الذي تُبنى عليه العديد من أسعار الفائدة الأخرى في الاقتصاد، مثل قروض الرهن العقاري وقروض الشركات. إن خفض هذه التكاليف يجعل الاستثمار والإنفاق أكثر جاذبية، مما يدعم النمو الاقتصادي. - زيادة السيولة في النظام المالي:
في أوقات الأزمات المالية، تميل البنوك إلى التوقف عن إقراض بعضها البعض بسبب الخوف وعدم اليقين، مما يؤدي إلى “تجمد” أسواق الائتمان. يقوم التيسير الكمي بضخ كميات هائلة من السيولة في النظام المصرفي، مما يمنح البنوك الثقة والموارد اللازمة لاستئناف عمليات الإقراض الطبيعية وضمان استقرار النظام المالي. - دعم أسعار الأصول وتحقيق تأثير الثروة:
يهدف التيسير الكمي إلى رفع أسعار الأصول المالية مثل الأسهم والسندات. هذا لا يساعد فقط على استقرار الأسواق المالية، بل يخلق أيضاً “تأثير الثروة”. عندما يرى الأفراد أن قيمة محافظهم الاستثمارية وممتلكاتهم العقارية ترتفع، فإنهم يشعرون بثقة أكبر في وضعهم المالي، مما يدفعهم إلى زيادة الإنفاق، وهو ما يعزز بدوره النشاط الاقتصادي. إن هذا الهدف من برامج التيسير الكمي هو أحد أكثر الجوانب التي تخضع للنقاش والتحليل.
التيسير الكمي في الممارسة: تجارب تاريخية بارزة
لم يعد التيسير الكمي مجرد نظرية اقتصادية، بل أصبح حقيقة واقعة شكلت المشهد الاقتصادي العالمي خلال العقدين الماضيين. التجربة اليابانية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كانت أول تطبيق واسع النطاق لما يمكن اعتباره شكلاً مبكراً من أشكال التيسير الكمي، حيث كافح بنك اليابان “العقد الضائع” من الانكماش والركود. ومع ذلك، كانت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 هي التي دفعت التيسير الكمي إلى الصدارة العالمية. أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) سلسلة من برامج التيسير الكمي الضخمة (QE1, QE2, QE3) التي شهدت شراءه لآلاف المليارات من الدولارات من السندات الحكومية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مما أدى إلى تضخم هائل في ميزانيته العمومية. يعتقد الكثير من المحللين أن هذه الجولات من التيسير الكمي كانت حاسمة في منع انهيار النظام المالي واستعادة الثقة وتحقيق استقرار الاقتصاد الأمريكي.
في أوروبا، اتبع البنك المركزي الأوروبي (ECB) مساراً مشابهاً، وإن كان متأخراً بعض الشيء، لمكافحة أزمة الديون السيادية الأوروبية وخطر الانكماش في منطقة اليورو. برنامج التيسير الكمي الذي أطلقه البنك المركزي الأوروبي ساعد في خفض تكاليف الاقتراض للحكومات المثقلة بالديون مثل إيطاليا وإسبانيا، ولعب دوراً محورياً في الحفاظ على وحدة منطقة اليورو. كما لجأ بنك إنجلترا (Bank of England) إلى التيسير الكمي بقوة بعد أزمة 2008، ومرة أخرى لمواجهة التداعيات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit). وفي الآونة الأخيرة، مع تفشي جائحة كوفيد-19 في عام 2020، شهد العالم موجة غير مسبوقة ومنسقة من التيسير الكمي، حيث قامت البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم بتوسيع برامجها بشكل كبير لتوفير الدعم اللازم للأسواق والاقتصادات التي توقفت فجأة بسبب عمليات الإغلاق. هذه التجارب التاريخية تظهر أن التيسير الكمي أصبح أداة لا غنى عنها في صندوق أدوات البنوك المركزية لمواجهة الأزمات الكبرى.
الآثار الإيجابية المحتملة للتيسير الكمي على الاقتصاد
عندما يتم تنفيذه بفعالية وفي السياق المناسب، يمكن أن يحقق التيسير الكمي مجموعة من النتائج الإيجابية التي تساهم في إنقاذ الاقتصاد من أزمات عميقة. الأثر الأكثر فورية هو استعادة الاستقرار في الأسواق المالية. ففي خضم الذعر المالي، يعمل البنك المركزي كـ “مشتري الملاذ الأخير”، مما يضمن وجود طلب على الأصول الرئيسية ويمنع حدوث عمليات بيع جماعية كارثية. هذا الاستقرار يعيد الثقة للمستثمرين ويسمح للأسواق بالعمل بشكل طبيعي مرة أخرى. علاوة على ذلك، فإن خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل الذي يسببه التيسير الكمي له فوائد واسعة النطاق. فهو لا يقلل فقط من تكاليف خدمة الديون للحكومات، مما يمنحها حيزاً مالياً أكبر لدعم الاقتصاد، بل يخفض أيضاً تكاليف الاقتراض للشركات والأسر. هذا يمكن أن يترجم إلى زيادة في الاستثمار الرأسمالي من قبل الشركات، وتوسع في التوظيف، وزيادة في الإنفاق الاستهلاكي على السلع باهظة الثمن مثل المنازل والسيارات.
كما أن “تأثير الثروة” الناتج عن ارتفاع أسعار الأصول يمكن أن يكون محركاً مهماً للنمو. فعندما ترتفع قيمة الأسهم والعقارات، يشعر أصحاب هذه الأصول بأنهم أكثر ثراءً، مما يزيد من ميلهم للاستهلاك. هذا الطلب الإضافي يمكن أن يساعد في سد “فجوة الناتج” (Output Gap) التي تحدث أثناء فترات الركود. ربما يكون الإنجاز الأهم لسياسة التيسير الكمي هو قدرتها على منع الاقتصاد من الانزلاق إلى دوامة الانكماش المدمرة. من خلال زيادة المعروض النقدي وخلق توقعات بحدوث تضخم معتدل في المستقبل، يشجع التيسير الكمي على الإنفاق والاستثمار في الوقت الحاضر بدلاً من تأجيله. إن تجنب الانكماش، الذي ثبت تاريخياً أنه أصعب بكثير في المعالجة من التضخم المرتفع، هو في حد ذاته إنجاز كبير يبرر اللجوء إلى مثل هذه الأداة القوية. لذا، فإن فعالية التيسير الكمي تكمن في قدرته على العمل عبر قنوات متعددة لدعم الطلب الكلي ومنع السيناريوهات الاقتصادية الأسوأ.
المخاطر والتحديات المرتبطة بالتيسير الكمي
على الرغم من فوائده المحتملة، فإن التيسير الكمي لا يخلو من مخاطر وتحديات كبيرة، مما يجعله سياسة مثيرة للجدل. الخطر الأكثر شيوعاً هو إمكانية تسببه في تضخم مرتفع وغير منضبط على المدى الطويل. فمن خلال ضخ كميات هائلة من الأموال في الاقتصاد، هناك خطر من أن يتجاوز نمو المعروض النقدي قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع عام في الأسعار. وعلى الرغم من أن هذا الخطر لم يتحقق على نطاق واسع بعد أزمة 2008، إلا أنه ظهر بقوة في أعقاب برامج التيسير الكمي الضخمة التي طبقت خلال جائحة كوفيد-19، مما أجبر البنوك المركزية على التحول نحو تشديد السياسة النقدية بسرعة.
التحدي الكبير الآخر هو خطر تكوين فقاعات في أسعار الأصول. عندما يتم توجيه السيولة النقدية الهائلة الناتجة عن التيسير الكمي إلى الأسواق المالية، فإنها يمكن أن تدفع أسعار الأسهم والسندات والعقارات إلى مستويات لا تبررها الأساسيات الاقتصادية. انفجار هذه الفقاعات في المستقبل يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يثير التيسير الكمي مخاوف جدية بشأن تفاقم عدم المساواة في الدخل والثروة. بما أن هذه السياسة تعمل بشكل أساسي عن طريق رفع أسعار الأصول، فإنها تفيد في المقام الأول الأسر الأكثر ثراءً التي تمتلك نسبة كبيرة من هذه الأصول، في حين أن الأسر ذات الدخل المنخفض التي لا تملك استثمارات كبيرة قد لا تستفيد بنفس القدر، بل قد تتضرر من ارتفاع أسعار الإيجارات والسلع الأساسية. وأخيراً، هناك “مشكلة الخروج” (Exit Problem). إن عكس مسار التيسير الكمي، وهي عملية تعرف باسم التشديد الكمي (Quantitative Tightening – QT)، يعد أمراً بالغ الصعوبة. فبيع البنك المركزي للأصول التي تراكمت لديه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة، واضطراب في الأسواق المالية، وربما التسبب في ركود اقتصادي، مما يجعل البنوك المركزية مترددة في التخلي عن هذه السياسة بسهولة.
الفرق بين التيسير الكمي والسياسات النقدية التقليدية
لفهم الطبيعة “غير التقليدية” للتيسير الكمي، من الضروري مقارنته بأدوات السياسة النقدية التقليدية. الأداة الرئيسية التقليدية للبنوك المركزية هي التحكم في سعر الفائدة قصير الأجل (مثل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الولايات المتحدة). تقوم البنوك المركزية برفع هذا السعر لكبح التضخم وتبريد الاقتصاد، وخفضه لتحفيز الإقراض والنمو. يتم تنفيذ هذه التعديلات من خلال عمليات السوق المفتوحة الصغيرة والروتينية التي تهدف إلى الحفاظ على سعر الفائدة المستهدف دون تغيير حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي بشكل كبير. تعمل هذه الأداة بشكل جيد في الظروف الاقتصادية العادية.
لكن التيسير الكمي يتم اللجوء إليه عندما تفشل هذه الأداة التقليدية، وتحديداً عندما يصل سعر الفائدة قصير الأجل إلى الصفر أو ما يقاربه. في هذه المرحلة، لا يمكن للبنك المركزي خفضه أكثر لتحفيز الاقتصاد. هنا يأتي دور التيسير الكمي كأداة بديلة. بدلاً من التركيز على سعر الفائدة قصير الأجل، يركز التيسير الكمي على “الكمية” من خلال توسيع الميزانية العمومية بشكل متعمد وضخم. هدفه هو التأثير بشكل مباشر على أسعار الفائدة طويلة الأجل وظروف الائتمان الأوسع في الاقتصاد، وهو أمر لا تستطيعه السياسة التقليدية بنفس الفعالية. باختصار، إذا كانت السياسة التقليدية تشبه استخدام مفتاح ربط دقيق لتعديل محرك السيارة، فإن التيسير الكمي يشبه استخدام رافعة ثقيلة لرفع السيارة بأكملها. إنه أداة أقوى وأكثر شمولاً، ولكنه أيضاً أقل دقة ويحمل مخاطر أكبر. إن الانتقال من الاعتماد على السياسة التقليدية إلى تطبيق التيسير الكمي يمثل تحولاً جوهرياً في كيفية إدارة البنوك المركزية للاقتصاد في أوقات الأزمات.
مستقبل التيسير الكمي: هل هو أداة دائمة؟
بعد أن أثبت التيسير الكمي نفسه كأداة رئيسية في مواجهة أزمتين عالميتين خلال فترة قصيرة، يدور الآن نقاش واسع حول مستقبله ودوره في السياسة النقدية. السؤال المحوري هو: هل سيعود التيسير الكمي إلى كونه أداة استثنائية لا تُستخدم إلا في حالات الطوارئ القصوى، أم أنه أصبح جزءاً دائماً من مجموعة أدوات البنوك المركزية؟ يرى بعض الاقتصاديين أن الاقتصادات أصبحت “مدمنة” على السيولة الرخيصة التي يوفرها التيسير الكمي، وأن أي محاولة جادة لسحب هذا التحفيز (عبر التشديد الكمي) ستؤدي إلى اضطرابات حادة في الأسواق وربما ركود اقتصادي، مما سيجبر البنوك المركزية على العودة إلى التيسير الكمي مرة أخرى عند أول بادرة لأزمة.
من ناحية أخرى، هناك قلق متزايد بشأن الآثار طويلة الأجل لوجود ميزانيات عمومية ضخمة بشكل دائم لدى البنوك المركزية. هذا الوضع قد يطمس الخطوط الفاصلة بين السياسة النقدية والسياسة المالية، حيث يبدو أن البنك المركزي يمول بشكل غير مباشر الإنفاق الحكومي، مما قد يقوض استقلاليته على المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن الاعتماد المستمر على التيسير الكمي قد يقلل من حافز الحكومات لإجراء إصلاحات هيكلية ضرورية، حيث يمكنها الاعتماد على التحفيز النقدي لحل المشاكل قصيرة الأجل. يبدو أن المسار الأكثر ترجيحاً في المستقبل هو أن يظل التيسير الكمي أداة متاحة للاستخدام في الأزمات المستقبلية، خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة الطبيعية عالمياً، مما يعني أن البنوك المركزية ستصل إلى “الحد الأدنى الصفري” بسرعة أكبر. ومع ذلك، من المرجح أن يكون هناك تدقيق أكبر في كيفية استخدام التيسير الكمي، وربما يتم استكماله بأدوات جديدة ومبتكرة لتجنب بعض آثاره الجانبية السلبية، مثل تفاقم عدم المساواة. إن إرث عصر التيسير الكمي سيستمر في تشكيل النقاشات الاقتصادية لسنوات قادمة.
الخاتمة: تقييم إرث التيسير الكمي
في الختام، يمكن القول إن التيسير الكمي هو سيف ذو حدين. من ناحية، كان أداة لا تقدر بثمن في منع انهيار النظام المالي العالمي في عام 2008 وتجنب سيناريو الكساد العظيم، كما قدم دعماً حيوياً للاقتصادات خلال جائحة كوفيد-19. لقد أثبت قدرته على تحقيق الاستقرار في الأسواق، وخفض تكاليف الاقتراض، ومكافحة قوى الانكماش المدمرة. ومن هذا المنظور، فإن اللجوء إلى التيسير الكمي كان ضرورياً وناجحاً في تحقيق أهدافه العاجلة.
من ناحية أخرى، خلف التيسير الكمي وراءه إرثاً معقداً من التحديات والمخاطر، بما في ذلك تضخم الميزانيات العمومية للبنوك المركزية إلى مستويات فلكية، والمساهمة في تكوين فقاعات الأصول، وتفاقم عدم المساواة في الثروة. كما أن عملية الخروج من هذه السياسة، أو “التطبيع”، محفوفة بالمخاطر وقد تكون أكثر إيلاماً للاقتصادات مما كان متوقعاً. إن النقاش حول الفعالية النهائية للتيسير الكمي وتكاليفه طويلة الأجل سيستمر بلا شك. ما هو مؤكد هو أن التيسير الكمي قد غير بشكل دائم قواعد اللعبة في السياسة النقدية، وأصبح حقيقة لا يمكن تجاهلها في فهم وإدارة الاقتصادات الحديثة في أوقات الأزمات.
الأسئلة الشائعة
1. هل التيسير الكمي هو نفسه “طباعة النقود”؟
لا، هذا تبسيط شائع ومضلل. على الرغم من أن كلا المفهومين يؤديان إلى زيادة المعروض النقدي، إلا أن الآلية والتأثير مختلفان تماماً. “طباعة النقود” بالمعنى الحرفي أو المجازي (التمويل النقدي للعجز الحكومي) تعني عادةً أن البنك المركزي ينشئ أموالاً جديدة لتمويل الإنفاق الحكومي مباشرة، وهي عملية يمكن أن تؤدي بسرعة إلى تضخم مفرط لأنها تضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد الحقيقي دون سحب أي أصول في المقابل. أما التيسير الكمي فهو عملية أكثر تعقيداً، حيث يقوم البنك المركزي بإنشاء احتياطيات بنكية إلكترونية جديدة ويستخدمها لشراء أصول مالية، مثل السندات الحكومية، من البنوك التجارية في السوق الثانوية. هذه العملية هي في الأساس “تبديل للأصول” (asset swap)؛ حيث يحصل النظام المصرفي على أصل سائل للغاية (احتياطيات نقدية) مقابل أصل أقل سيولة (سندات). الأموال الجديدة تظل محصورة في البداية داخل النظام المصرفي كاحتياطيات، ولا تدخل الاقتصاد الحقيقي إلا إذا قامت البنوك بزيادة إقراضها للأفراد والشركات. لذلك، فإن تأثير التيسير الكمي على التضخم يعتمد بشكل كبير على سلوك البنوك والمستهلكين والمستثمرين، وهو ما يجعله أقل مباشرة وخطورة من التمويل النقدي المباشر.
2. كيف يؤثر التيسير الكمي بشكل مباشر على الشخص العادي؟
يؤثر التيسير الكمي على الأفراد العاديين من خلال عدة قنوات غير مباشرة. أولاً، من خلال خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، يجعل الاقتراض أرخص. هذا يعني أن تكلفة قروض الرهن العقاري لشراء منزل، أو قروض السيارات، أو القروض الشخصية الأخرى قد تنخفض، مما يشجع على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في العقارات. ثانياً، من خلال رفع أسعار الأصول المالية (“تأثير الثروة”)، يستفيد الأفراد الذين يمتلكون أسهماً في البورصة أو لديهم استثمارات في صناديق التقاعد، حيث يرون قيمة مدخراتهم ترتفع. ثالثاً، من خلال تحفيز الاقتصاد بشكل عام ومنع الركود العميق، يهدف التيسير الكمي إلى حماية الوظائف وتشجيع الشركات على التوظيف، مما يقلل من معدلات البطالة. ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك آثار سلبية أيضاً؛ فالمدخرون الذين يعتمدون على الفوائد من حسابات التوفير أو السندات يرون عوائدهم تتضاءل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم ارتفاع أسعار الأصول في زيادة تكاليف الإسكان، مما يجعل امتلاك منزل أكثر صعوبة على الشباب والوافدين الجدد إلى السوق.
3. ما هو الفرق الجوهري بين التيسير الكمي (QE) والتشديد الكمي (QT)؟
التيسير الكمي (QE) والتشديد الكمي (QT) هما عمليتان متعاكستان تماماً في السياسة النقدية. التيسير الكمي هو سياسة توسعية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد. يتم ذلك من خلال قيام البنك المركزي بشراء الأصول المالية، مما يؤدي إلى ضخ السيولة في النظام المصرفي، وزيادة حجم ميزانيته العمومية، وخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل. الهدف هو تشجيع الإقراض والاستثمار. على النقيض تماماً، التشديد الكمي هو سياسة انكماشية تهدف إلى كبح التضخم وتبريد الاقتصاد. يتم ذلك عن طريق عكس عملية التيسير الكمي؛ حيث يقوم البنك المركزي بتقليص حجم ميزانيته العمومية. يمكن أن يتم ذلك بطريقتين: إما عن طريق بيع الأصول التي اشتراها سابقاً في السوق المفتوحة، أو ببساطة عن طريق عدم إعادة استثمار العائدات من السندات عند استحقاقها. كلتا الطريقتين تؤديان إلى سحب السيولة من النظام المالي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل وجعل الائتمان أكثر تكلفة، وبالتالي إبطاء النشاط الاقتصادي. الانتقال من التيسير الكمي إلى التشديد الكمي يمثل تحولاً كبيراً من بيئة داعمة للأسواق إلى بيئة أكثر تقييداً.
4. لماذا لم يتسبب التيسير الكمي في تضخم جامح بعد الأزمة المالية عام 2008؟
كان هذا أحد أكبر المخاوف في ذلك الوقت، لكن التضخم المرتفع لم يتحقق لعدة أسباب اقتصادية رئيسية. أولاً، كانت “سرعة تداول النقود” (Velocity of Money)، أي المعدل الذي يتم به إنفاق الأموال في الاقتصاد، منخفضة للغاية. على الرغم من أن البنك المركزي ضخ كميات هائلة من الاحتياطيات في النظام المصرفي، إلا أن البنوك كانت حذرة واختارت الاحتفاظ بجزء كبير من هذه السيولة كاحتياطيات فائضة بدلاً من إقراضها بقوة، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي والتشديد التنظيمي بعد الأزمة. ثانياً، كان الاقتصاد يعاني من “فجوة إنتاج” سلبية كبيرة، مما يعني وجود طاقة إنتاجية فائضة وعمالة غير مستغلة (بطالة عالية). هذا الضغط الانكماشي القوي الناجم عن ضعف الطلب الكلي وازن التأثير التضخمي المحتمل لزيادة المعروض النقدي. ثالثاً، لعبت قوى العولمة والتقدم التكنولوجي دوراً في إبقاء الأسعار منخفضة. باختصار، كانت الأموال التي تم إنشاؤها محصورة إلى حد كبير في النظام المالي ولم تتدفق بالكامل إلى الاقتصاد الحقيقي بالسرعة الكافية لإحداث تضخم كبير في أسعار السلع والخدمات، بل ذهب جزء كبير منها إلى رفع أسعار الأصول المالية.
5. هل يمكن للدول النامية استخدام التيسير الكمي بفعالية؟
استخدام التيسير الكمي في الاقتصادات النامية أو الناشئة محفوف بمخاطر أكبر بكثير مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، ولذلك نادراً ما يتم اللجوء إليه. السبب الرئيسي هو الافتقار إلى “المصداقية الهائلة” التي تتمتع بها عملات الاحتياطي الرئيسية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو. عندما يقوم بنك مركزي في دولة متقدمة بتنفيذ التيسير الكمي، يثق المستثمرون الدوليون بأن التضخم سيظل تحت السيطرة. أما في دولة نامية، فإن مثل هذه السياسة قد يُنظر إليها على أنها تمويل مباشر للعجز الحكومي، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في العملة المحلية. هذا يمكن أن يسبب هروباً سريعاً لرؤوس الأموال، وانخفاضاً حاداً في قيمة العملة، وارتفاعاً كبيراً في التضخم المستورد. علاوة على ذلك، غالباً ما تكون الأسواق المالية في هذه البلدان أقل عمقاً وسيولة، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي شراء كميات كبيرة من الأصول دون التسبب في تشوهات سعرية حادة. لذلك، بينما قامت بعض الاقتصادات الناشئة الكبرى بتجارب محدودة مع شراء الأصول، يظل التيسير الكمي أداة أكثر ملاءمة وأماناً للدول ذات العملات الاحتياطية والأسواق المالية المتطورة.
6. ما هي “قناة إعادة توازن المحافظ الاستثمارية” في التيسير الكمي؟
تعد “قناة إعادة توازن المحافظ الاستثمارية” (Portfolio Rebalancing Channel) إحدى الآليات الرئيسية التي ينتقل من خلالها تأثير التيسير الكمي إلى الاقتصاد. تبدأ الفكرة عندما يقوم البنك المركزي بشراء كميات كبيرة من الأصول الآمنة، مثل السندات الحكومية طويلة الأجل، من المستثمرين (مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين). هذه العملية تسحب هذه الأصول الآمنة من السوق وتستبدلها بالنقد في محافظ المستثمرين. بما أن المستثمرين لا يرغبون عادةً في الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقد منخفض العائد، فإنهم يسعون إلى “إعادة توازن” محافظهم عن طريق استخدام هذه السيولة لشراء أصول أخرى ذات مخاطر أعلى وعوائد محتملة أكبر، مثل سندات الشركات، والأسهم، وحتى العقارات. هذا الطلب المتزايد على الأصول الأكثر خطورة يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وخفض تكاليف التمويل للشركات، مما يشجعها على الاستثمار والتوسع. وبالتالي، فإن هذه القناة تعمل على نشر تأثيرات التيسير الكمي من سوق السندات الحكومية الآمنة إلى مجموعة أوسع من الأصول في جميع أنحاء الاقتصاد.
7. كيف يؤثر التيسير الكمي على أسعار صرف العملات؟
يميل التيسير الكمي عموماً إلى إضعاف عملة البلد الذي يطبقه، وذلك من خلال آليتين رئيسيتين. أولاً، يؤدي التيسير الكمي إلى خفض أسعار الفائدة المحلية طويلة الأجل. هذا يجعل الاحتفاظ بالأصول المقومة بالعملة المحلية (مثل السندات) أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب مقارنة بالاستثمار في بلدان أخرى تقدم عوائد أعلى. ونتيجة لذلك، يقل الطلب على العملة المحلية في أسواق الصرف الأجنبي، مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها. ثانياً، زيادة المعروض النقدي الناتجة عن التيسير الكمي يمكن أن تخلق توقعات بتضخم أعلى في المستقبل، مما يقلل من القوة الشرائية للعملة ويؤدي إلى تآكل قيمتها بمرور الوقت. يعتبر ضعف العملة أحياناً هدفاً ضمنياً للتيسير الكمي، حيث إنه يجعل صادرات البلد أرخص وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يوفر دفعة إضافية للنمو الاقتصادي. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا إلى “حروب عملات” تنافسية، حيث تقوم الدول الأخرى بتخفيض قيمة عملاتها رداً على ذلك.
8. ما هي أبرز الانتقادات الأكاديمية الموجهة لسياسة التيسير الكمي؟
من منظور أكاديمي، تتجاوز الانتقادات المخاوف العامة من التضخم. أحد الانتقادات الرئيسية هو أنه يخلق “خطراً أخلاقياً” (Moral Hazard)، حيث يشجع الحكومات على تراكم الديون المفرطة والشركات على اتخاذ مخاطر مفرطة، ثقةً منها بأن البنك المركزي سيتدخل لإنقاذ الأسواق عند حدوث أي أزمة. نقد آخر هو أن التيسير الكمي “يشوه إشارات الأسعار” في الأسواق المالية. فمن خلال قمع أسعار الفائدة بشكل مصطنع، فإنه يعطل آلية السوق في تقييم المخاطر وتخصيص رأس المال بكفاءة، مما قد يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد واستثمارات غير منتجة. كما يجادل بعض الاقتصاديين بأن تأثيره على الاقتصاد الحقيقي ضعيف وغير مؤكد، بينما تأثيره على تضخيم أسعار الأصول وتفاقم عدم المساواة واضح ومباشر. وأخيراً، هناك قلق بشأن استقلالية البنك المركزي، حيث إن شراء كميات هائلة من الديون الحكومية يطمس الخط الفاصل بين السياسة النقدية والسياسة المالية، مما قد يعرض البنك لضغوط سياسية لتمويل الإنفاق الحكومي بشكل دائم.
9. هل هناك حد أقصى لحجم الميزانية العمومية للبنك المركزي؟
نظرياً، لا يوجد حد أقصى محدد لحجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، حيث يمكنه إلكترونياً إنشاء احتياطيات بكميات غير محدودة لشراء الأصول. ومع ذلك، هناك حدود عملية واقتصادية كبيرة. كلما زاد حجم الميزانية العمومية، زادت المخاطر المحتملة. أحد المخاطر هو فقدان السيطرة على التضخم إذا بدأ الاقتصاد في النمو بسرعة وبدأت البنوك في إقراض جميع الاحتياطيات التي تراكمت لديها. الخطر الآخر هو “خسائر الميزانية العمومية” للبنك المركزي نفسه؛ فإذا اضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم، فإن قيمة السندات طويلة الأجل منخفضة العائد التي يحتفظ بها ستنخفض، مما قد يؤدي إلى خسائر محاسبية. على الرغم من أن البنك المركزي لا يمكنه الإفلاس بالمعنى التقليدي، إلا أن هذه الخسائر يمكن أن تكون لها تداعيات سياسية وتقوض مصداقيته. علاوة على ذلك، فإن الميزانية العمومية الضخمة بشكل مفرط يمكن أن تشوه عمل الأسواق المالية لدرجة أنها لم تعد تعمل بكفاءة. لذلك، بينما لا يوجد رقم دقيق، فإن الحجم المستدام للميزانية العمومية يحده في النهاية استقرار الأسعار والاستقرار المالي.
10. ما هي البدائل المتاحة للتيسير الكمي عندما تكون أسعار الفائدة عند الصفر؟
عندما تصل أسعار الفائدة إلى الصفر وتصبح السياسات التقليدية غير فعالة، يمتلك البنك المركزي بعض الأدوات غير التقليدية الأخرى بالإضافة إلى التيسير الكمي. أحد البدائل هو “التوجيه المستقبلي” (Forward Guidance)، حيث يلتزم البنك المركزي علناً بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة في المستقبل، حتى بعد تعافي الاقتصاد. يهدف هذا إلى خفض توقعات أسعار الفائدة المستقبلية والتأثير على العوائد طويلة الأجل. أداة أخرى هي “أسعار الفائدة السلبية” (Negative Interest Rates)، حيث يتم فرض رسوم على البنوك التجارية مقابل الاحتفاظ باحتياطياتها لدى البنك المركزي، مما يهدف إلى تحفيزها على إقراض الأموال بدلاً من تخزينها. هناك أيضاً سياسات أكثر جذرية مثل “أموال الهليكوبتر” (Helicopter Money)، حيث يقوم البنك المركزي بتوزيع الأموال مباشرة على المواطنين، أو سياسات تستهدف التحكم في منحنى العائد (Yield Curve Control)، حيث يلتزم البنك بشراء أي كمية من السندات الحكومية اللازمة للحفاظ على عائدها عند مستوى مستهدف معين. كل من هذه الأدوات له مجموعة من الفوائد والمخاطر الخاصة به، ويمثل التيسير الكمي الخيار الأكثر شيوعاً واختباراً حتى الآن.